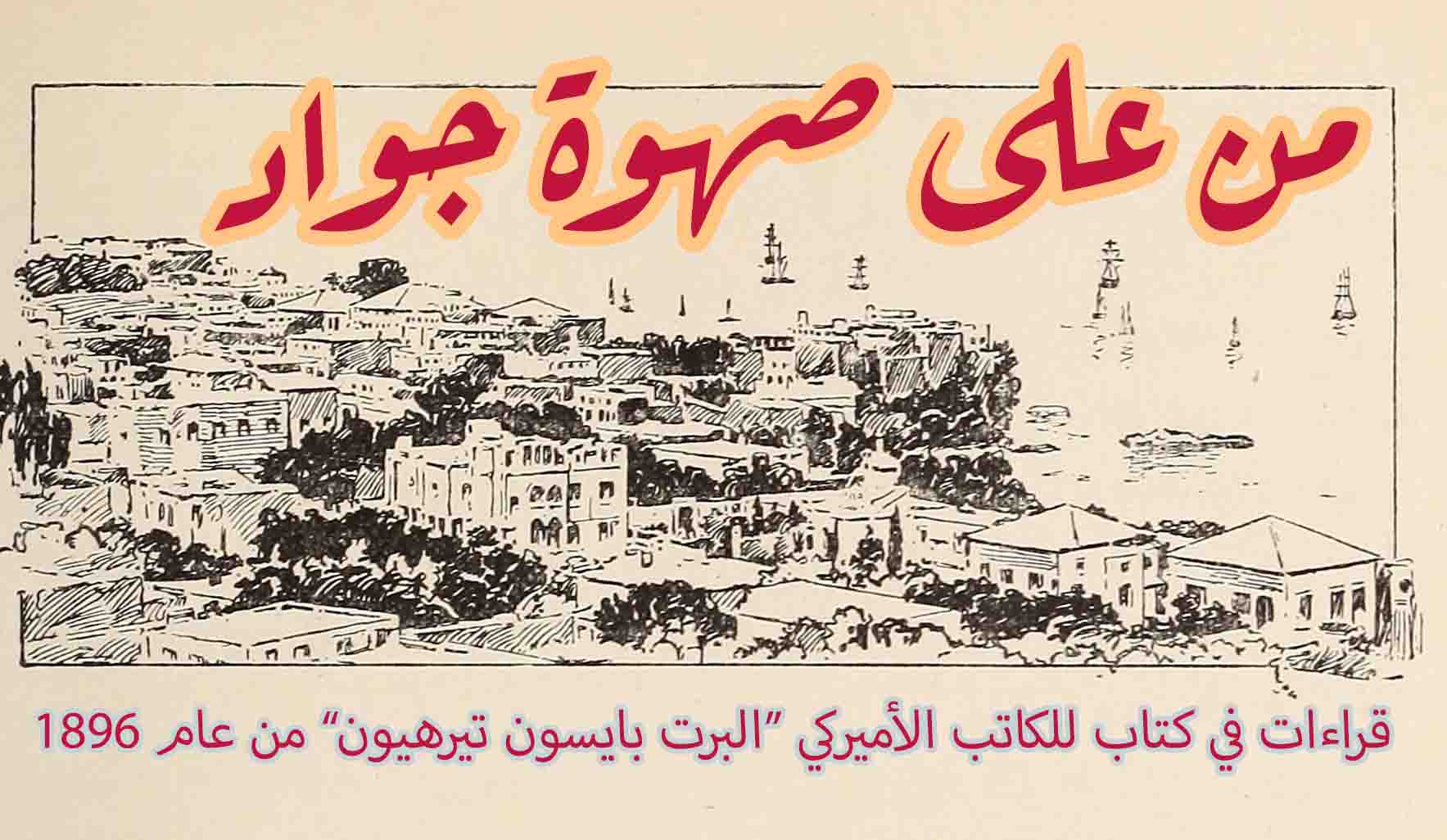البرت بايسون تيرهيون, هو كاتب وصحفي أميركي وُلد في عام 1872, وبعد تخرجه من جامعة كولومبيا, سافر في رحلة الى الشرق وزار مصر وفلسطين ولبنان وسوريا, و صدر له اول كتاب له في عام 1896, تحت عنوان “سوريا من على صهوة جواد”.
اعتبر “تيرهيون” أن كتابه هذا ليس عملا توثيقيا او تأريخياً, فقد سبقه في ذلك الكثيرون من اساطين الفكر والعلم والادب الذين الّفوا مئات المجلدات حول الأمور العلمية أو الأثرية أو التاريخية المتعلقة بالأرض المقدسة, وانما يقدّم بكل بساطة, قصة إقامة عابرة في ارض الشرق, ووصف لهذه الأرض كما رأتها عيني شاب “أراد أن يحصل على بعض الحقائق التاريخية والمقدسة”, ومعتبرا انّ كتابه هو على الأقل “حكاية مسافر شعر بعمق بضرورة التشبث دائمًا بتلك الأرض الميتة التي كانت مهد إيماننا العظيم”.
يبدأ ” تيرهيون ” قصته من على ظهر سفينة مغادراً مرفأ يافا مع حلول الظلام, ليصل إلى بيروت فجر اليوم الثاني حوالي الساعة السادسة صباحاً. “بيروت هي البلدة, الأكثر روعة وحداثة من يافا, ترتفع عن الشاطئ وتنتصب على قمّة تل حيث البيوت البيضاء والصفراء تتلألأ بالحدائق وأشجار النخيل, ويتوّجها مباني الكلية الأميركية”.
ثم يصف لنا “تيرهيون” مشهدا طالما قرأنا عنه في كتب الرحالة والمسافرين عن لحظة وصول سفنهم الى بيروت, حيث يسارع اشخاص في قواربهم الصغيرة للاحاطة بالسفينة العاجزة عن دخول المياه الضحلة في الميناء القديم, فيلاقون الركاب ويعرضون نقلهم الى البر, أو لتقديم العروض المغرية لغرف الفنادق او أجار البيوت؛ “في الميناء, أحاط بالسفينة حشد من السكان المحليين بقواربهم وهم يلبسون ثيابا مبهرجة, و فيما بدأ بعضهم تسلق حواجز السفينة, كان آخرون يصرخون لنا من قواربهم بعدة لغات, ويشيرون بمفاتيح مختلفة” للدلالة على أن لديهم غرفا جاهزة للأجار.
وكمشهد سينمائي, ينتقل بنا الى ظهر السفينة لنرى من خلال كلماته “طوابير طويلة من الرجال تحملُ البضائعَ من المخزن, لتتشابك الأمور و تختلط بشكل ميؤوس منه”, وليكتمل المشهد بوصول حشد من الباعة الذين كانوا يحاولون بيع قطع أثرية يدّعون انها حقيقية ومن أعماق التاريخ. “وهؤلاء الباعة, جاء من يزاحمهم أيضا على متن السفينة؛ جيش الملاحين و المرشدين الذين حضروا لالتقاط العملاء او – الضحايا – كما يسمونهم, وسط خليط عجيب من الضجيج والأصوات. وبدأت أتساءل عما إذا كان ذلك سينتهي , و سنتمكن من الوصول إلى الشاطئ بسلام!, ليفاجأني رجل يخرج من بين الحشود ويتقدم نحوي. كان متوسط القامة, عريضًا, وقوي البنية. كنت أعرفه بالفعل من خلال ما سمعته عنه، ورأيت صورته, فسألته:” هل أنت داوود جمال؟”.
اتفق “تيرهيون” مع “جمال” سابقاً لمقابلته في بيروت والعمل كمرشد له اثناء تجواله في البلاد. وداوود هذا يصفه بأنه “من القلائل الذين يمكن توظيفهم, والاعتماد عليهم في هذا النوع من الاعمال, فلقد مررت بتجارب مع العديد من المرشدين أثناء إقامتي في الشرق, ولم أجد الا ثلاثة منهم يستحقون حقًا توظيفهم؛ وهم إبراهيم أيوب الدمشقي, وديمتريوس دوميان من القدس, وقبل كل شيء وعلى رأسهم داوود جمال هذا”.
يتابع “تيرهيون” كيل المديح لهذا المرشد فيقول:” معه, سيعني السفر لي كثيرا. وبجهوده, سأتمكن من رؤية الكثير من الأشياء التي يمر بها عادة المسافرون عبر سوريا, ولا يلاحظونها”.
وصل الكاتب والصحفي الأميركي “البرت بايسون تيرهيون” الى بيروت على متن سفينة قادمة من يافا, و هاله منظر الزحام الذي استجد على ظهر السفينة من باعة و مرشدين و دلّالين لغرف الفنادق و بيوت الأجار, الى ان التقى المرشد والمترجم داوود جمال الذي سبق واتّفق معه لمرافقته في رحلته في البلاد.
لا يغيب عن “تيرهيون” ان يزيد في التعريف بداوود, فهو ينحدر من عائلة مسيحية راقية في القدس, لكنه بسبب افلاس والده, اضطر في شبابه إلى العمل كدليل ومترجم للسواح والرحالة الأجانب, فهو درس الكتاب المقدس وكل ما يتعلق بجغرافية البلاد, ويعرف كل ميلٍ من الأرض وكل حدث تاريخي مرتبط به؛ كما يعرف الكثير من الناس و أبناء القبائل والتقاليد مما يقلّل من مضايقات السفر إلى الحد الأدنى.
وسط الزحام الذي تكلمنا عنه, أشار “تيرهيون” الى أمتعته التي قام داوود بنقلها بسرعة الى قاربه, وجذّف به متّجهاً الى الشاطئ حيث دار الجمارك, التي لم يجد وصفاً حقيقياً لها إلّا بالكلمة العربية “جهنم” قائلاً:” لقد تفاجأت بما يجري هنا. لقد بدا كأنني أرى مشهداً من فصل “الجحيم” من كتاب “الكوميديا الإلهية لدانتي” حيث اضطررت للعيش فيه لمدة نصف ساعة حتى جاء دوري للحصول على وثيقتي. ورأيت أيضا مجموعة من المحليين قد عادوا لتوهم من معرض عالمي خارج البلاد, ورأيت العاملين في دار الجمارك المحرومين من نعمة السفر كيف يستغلون إخوانهم العائدين, وينغّصون عليهم متعة السفر ويذيقونهم اشكالاً من المتاعب”.
يقف “تيرهيون” في دار الجمارك, حيث لا شيء يسير بشكل طبيعي. صناديق وحقائب مفتوحة, ونقاشات بأصوات عالية بين المسافرين والمسؤولين هنا, واتهامات بالتهريب, واحتجاجات تتصاعد وصراخ بشأن وثائق السفر وصلاحياتها, وأشخاص آخرون يتعثرون بالأمتعة المتناثرة.
يسرّ “تيرهيون” كثيرا عندما يعلم ان أمتعته سليمة ولا ملاحظة عليها, فيخرج مع دليله “داوود” الى الشارع الذي يبدو هادئاً تقريبًا بخلاف الضجيج الذي كان به منذ قليل.
متاعب “تيرهيون” لم تنته بعد, فهناك مشكلة كانت بانتظاره ويخبرنا عنها كالتالي:” أرسل داوود الأمتعة إلى فندق الشرق؛ ثم أخذنا أنا وهو عربة لنلحق بها. وقبل أن نبدأ أحاطت بنا مجموعة من المتسولين, مع صرخاتهم التي كثيرًا ما قرأنا عنها : “بخشيش! خواجه, بخشيش”.
قرأنا كثيرا عن ازعاج المتسولين للمسافرين المحليين أو الأجانب القادمين الى بيروت وخاصة عند أبواب الفنادق, ولكن “تيرهيون” أضاف تفاصيل مثيرة ودقيقة عنهم فيقول :”المتسولون هنا لا يشبهون امثالهم في الغرب أبداً؛ ولم أر مثلهم في حياتي. انهم قذرون وبغيضون ومرضى ويستخدمون وسائل مثيرة للاشمئزاز. جاء الينا مشلولون, و آخرون يلفّون أذرعهم وأرجلهم بخرق قذرة مدعين انها مصابة, ورجال مكفوفون مع تجاويف عيون متقيحة. والأكثر بغضا كانوا الرجال ذوو البنية الجيدة في معظم أنحاء أجسادهم, ولكن لديهم تشوهات في الأيدي أو الأقدام يكشفونها عارية امام الناس لاستجلاب الشفقة وجمع الصدقات. لا أدري ان كانوا فعلا وُلِدوا كذلك, ام انهم فعلوا شيئا لمنع هذه الأطراف من النمو كي تكون لهم مصدر كسب للمال”.
بعد خروجه من مبنى الجمارك في ميناء بيروت, ولقائه مجموعة من الشحاذين الذين تراكضوا اليه طالبين البخشيش, ركب “البرت بايسون تيرهيون” العربة متجها الى حيث سيبيت ليلته. وفي الطريق بدأ يرسم لنا بكلماته صوراً لبيروت نهاية القرن التاسع عشر التي كانت تمرّ أمامه؛ صوراً بعضها تكرر مع الكثيرين من زوار المدينة و عابريها, والبعض الآخر يشكّل إضافة لطيفة الى ذاكرتنا النائمة على ضفاف الحنين.
“ناس وبيوت تتناقض مع شوارعنا الأمريكية. نرى هنا مبانٍ من الحجر البني وعلى سطوحها القرميد الأحمر, ورجال يرتدون بذلات سوداء ورمادية و بنّية, فالموضة متساهلة ولا تتبدل بسهولة. الطربوش اللامع مع العباءة ذات اللونين الأبيض والبني, والوشاح المتدلي من الكتف إلى الركبة وسترات وسراويل مختلفة حسب أذواق مرتديها من الرجال. أما أزياء نساء المدينة ومنهن المحجّبات فهي بشكل عام متعددة الألوان”.
وفي مشهد آخر يضجّ بالحركة والأصوات, يحدثنا “تيرهيون” عن قافلة من الإبل “مرّت من أمامنا, ومع وجود الحمير والخيول سدّت الطريق. وفي وسط كل ذلك الزحام, كانت كلاب الشوارع اللئيمة تتسلل تحت العربات, أو تنام في بقع حيث يتسلل ضوء الشمس. هذه الكلاب لا يملكها أحد, فأهل الشرق لا يقتنون الكلاب, ولكنها فقط تسرح في الشوارع, تأكل كل فضلاتها وجيفها, وبذلك ربما تخفّف عن الناس عناء تنظيف شوارعهم أو دفن الحيوانات النافقة فيها”.
“الشوارع السفلية لبيروت ضيّقة ومتعرجة, و على كل جانب من الطريق تنتشر المتاجر والمقاهي والبازارات, ويجلس الرجال على الأرصفة الضيقة – ان وجدت – يلعبون الشطرنج أو يشربون القهوة”.
بعد ذلك “تسلقنا التل بعربتنا, ووصلنا إلى طريق أبيض أوسع ، حيث يوجد منازل باللونين الأصفر والأبيض وسطوحها حمراء, ومحاطة بأشجار النخيل والصبار. و هنا وهناك, ترى قباب المساجد وترتفع المآذن البيضاء باتجاه السماء الزرقاء”.
“تتمتع المدن تقريبًا ببعض الألوان التي تميّزها. لندن معروفة بالرمادي الداكن. مدننا الأمريكية يغلب عليها اللون الأحمر والبني. لكن اللون السائد هنا في الشرق هو الأبيض. وبيروت لو نظرت اليها من الأعالي لتأكد لنا أنها بيضاء, و يزيدها وهج الشمس بياضا.
بيروت أوروبية تمامًا عند مقارنتها بالعديد من المدن [في الشرق], ولكن بالنسبة للمسافر الذي يتوقّف هنا للمرة الأولى فسيبدو له وكأنه في عالم جديد”.
رحلة “تيرهيون” في العربة, شكّلت فرصة له لمسح كل شيء تراه عيناه, مستعينا بدقة الملاحظة والفضولية التي يملكهما كصحفي وكاتب ومن ذلك معرفة حقيقة تميمة الخرزة الزرقاء. “لاحظت على مقدمات العديد من الخيول والحمير خرزات زرقاء, وسألت “داوود” عن وجهة استخدامها, فقال لي إنها لرد العين الشريرة؛ عين الحسد التي يخشاها السكان هنا, ويعتقدون أنه إذا اشتُهيَت [أملاكهم أو حيواناتهم أو أولادهم] فسوف يكون مصيرهم الخراب أو المرض والموت. لذلك يربطون خرزة زرقاء على أفضل خيولهم, وحتى حول أعناق أطفالهم. ورأيت أطفالًا آخرين لفّهم أهاليهم بخرق بالية معتقدين انه بهذا المظهر, عين الحسد لا تصيبهم”.
أراد “البرت بايسون تيرهيون” اقتناص فرصة وجوده في بيروت للتعرف على أماكن اللهو المحلية, و كيف يمضي الناس أوقات فراغهم, فعرض عليه مرافقه داوود الذهاب الى مقهى محلي للتعرف بنفسه على كل التفاصيل التي قد تثير فضوله.
“تنتشر في بيروت أماكن ترفيهية أكثر من القدس ودمشق, و منها المقاهي في الهواء الطلق, حيث تُقدّم انواع المشروبات والنرجيلة على طاولات مغطاة بالرخام, تذكّر بمقاهي الشارع في باريس. وليس لدى هذه المقاهي ما يحفّز الأجانب للمجيء اليها, و لكنها للطبقة المتوسطة والدنيا هنا فهي مثيرة للاهتمام وتكفي حاجاتهم. والى واحدة من هذه المقاهي أخذني “داوود” في المساء”.
“يتألف المقهى من غرفة مفردة, ومفتوحة على الشارع من جهة واحدة. مقاعدها منخفضة وتقوم على ثلاثة ركائز. وعلى الجدار رف مليء بالنراجيل والأكواب والقناني. بينما في أحدى الزوايا يوجد منقل من النحاس حيث تُصنع القهوة الطازجة طوال الوقت, وبجانبه يوجد صينية بها فناجين قهوة صغيرة”.
“المقهى مثل معظم أماكن التسلية الشرقية؛ بسيطة وخالية تمامًا من الزخرفة. لا صور؛ فالإسلام يحرّمها, وحتى لو علّق بعضها سيفسدها الدخان”.
“عندما وصلنا إلى المقهى , كان فيها ما لا يقل عن أربعين رجلاً. بعضهم يجلس على مقعد طويل او مقاعد صغيرة, والبعض الآخر يجلس على حصائر وُزعت حول كرسي واحد يجلس عليها شخصية ملفتة للنظر؛ رجل طويل نحيف يرتدي ملابس غريبة الأطوار”.
طبعا, “تيرهيون” رأى ما نعرفه بالحكواتي, يجلس باعتزاز على كرسيه ملكاً, و يتحلق حوله الناس للإستماع الى روايات خيالية وقصصا فيها من كل ضروب الإمتاع, من القوة و الحب و الشجاعة و الفروسية و شعر الغرام و ضرب السيوف, مما يجذب الناس ويرغمهم على المجيء الى المقهى في كل ليلة, في خطة محكمة للتسويق يبدو انها كانت تحقق نجاحا بارزاً.
وصف “تيرهيون” الراوي فقال: “حذاء أحمر وسروال أوروبي في النصف السفلي من جسده: في حين يلبس في الجزء الأعلى سترة قرمزية ضيقة ومطرزة بخيوط ذهبية وأكمام بيضاء منفوخة على شكل تلك التي ترتديها النساء في بلدنا. اما على الرأس فطربوش أحمر يغطي جزءا من ضفائر الشعر”.
“الحشد ينظرون اليه باهتمام واضح بانتظار تغيير ما في تعابير وجهه. وعيناه الداكنتان تتحركان في كل الاتجاهات لتمثل الغضب في لحظة واحدة, ثم نظرة حزن أو خوف في لحظات ستأتي لاحقا.
كان يشير بيديه بعنف, و يتحدث في نغمات عميقة تصدر من حلقه, ثم بصوت عالي وكأنه على مسرح اوبرا. الرجال صامتون, وأحيانًا يهزون برؤوسهم او يتهامسون فيما بينهم. أما عندما يصدح صوته فتختفي الضوضاء الى حين يسكت مجددا, فيحدق في السماء ليسود صمت دام أكثر من دقيقة ، ثم كسر هذا السكون بالصياح مجددا مكملاً ما كان يتحدث فيه”.
طبعاً “البرت بايسون تيرهيون” لم يكن يفهم أي شيء مما يقوله الراوي, فاستغل فترة صمت عابرة فهمس في أذن داوود سائلاً اياه :”ما الذي يجري؟ أهي الانتخابات السياسية؟” . رد عليه :”ما هي الانتخابات يا سيدي؟”
انتبه “تيرهيون” الى حماقة سؤاله ولم يكرره, لكنه سأل بطريقة مغايرة:”ماذا يقول هذا الرجل؟”.
فأجاب داوود: “إنه راوي قصص محترف” وتابع: “يأتي الفقراء إلى هنا لأنهم لا يستطيعون الذهاب إلى أحد الأماكن الباهظة الثمن. يدفعون فلسًا واحدًا مقابل القهوة ، ثم فلسًا آخراً لهذا الرجل, ويخبرهم القصص طوال المساء. لقد أنهى للتو واحدة, وهو سيبدأ بواحدة أخرى بعد دقيقة “.
القصة التي يرويها هذا الحكواتي كانت عن أمير أحبّ ابنة ملك فخطفها, فلحقهما الملك بجيش جرار. وهكذا تدور أحداث تمتد الى ما لا نهاية, ولكم أن تتخيلوا كم ستطول الرواية التي اعتبرها “تيرهيون” بأنها انعكاس للأهتمام هنا بالرومانسية وبالأمور الطفيفة على حساب الواقعية.
تعرّف “البرت بايسون تيرهيون” الى مقاهي بيروت البسيطة التي يرتادها عامة الناس ولا يدفعون فيها الّا فلساً واحدا مقابل فنجان قهوة والاستمتاع برواية اسطورية وحماسية من الحكواتي.
هذه المرة, أراد “تيرهيون” ان يذهب الى مكان آخر, فاقترح على مرافقه “داوود” ان يذهبا الى مسرح محلي. قبلَ “داوود” على مضض, فهو لم يزر مكاناً من هذا النوع من قبل, و هو متدين ومتزوج ولا تتماشى عاداته مع “تخصصات تلك الأمسية”.
لم يحدد “تيرهيون” في كتابه اسم المسرح ولا مكانه, و لكن وصَفهُ بأنه “يتسع لخمسمئة شخص, وكان اكثر من نصفه ممتلئًا. وهو مثل المقهى الذي زرناه, من غير زخرفة, و لم يكن بين الحضور أي امرأة, وكنت انا الأجنبي الوحيد”.
“كان الجزء الأول من المسرحية جاريًا عندما دخلنا. على المسرح وهو مجرد منصة خالية من المناظر الطبيعية, جلس ثلاثة رجال وامرأتان, يعزفون على الآت موسيقية محلية ويغنون. بعد أغنية أو اثنتين ، جاءت إحدى النساء – وهي فتاة يهودية جميلة ذات ملامح يونانية – إلى مقدمة المسرح وبدأت في الرقص. كنت قد سمعت الكثير عن رقصات الشرق الحالمة, ولكنني أُصبت بخيبة أمل, اذا تألفت الرقصة من خليط محرج لحركات القدمين وتلويحات لا حصر لها من اليدين مع غناء بطيء بلا نغمة محددة”.
ثم أتبعت الفتاة رقصتها بأغنية في مدح حبيبها مستخدمة فيها تشبيهات واستعارات كثيرة وتقليدية مثل: عيون الغزال وحواجب كالسيف, وشعر ناعم كالحرير, وفم احمر , وقامة مثل النخلة.
“كان التمثيل جيدًا , وأدى كل شخص دوره بنجاح رغم الأخطاء الطفيفة. وكان “داوود” اخبرني خلال العرض أن الممثلين كانوا يهوداً أتوا من دمشق وهم غير متعلمين و لا مُدَربين, و هم ممن لا يقرأون ولا يكتبون, وما سمعناه وشاهدناه خلال العرض من حوارات واغنيات وحركات قاموا بأنفسهم بتأليفها وحفظها وتأديتها”.
انتهى العرض, وخرج “تيرهيون” من المسرح و”داوود” معه ينظر اليه وكأنه يعتذر عن العرض مؤكداً من حين لآخر أنه لم يزر مثل هذه الأماكن من قبل, وانه لو زارها لعرف مستوى الأداء و ما يُقدم فيها.
قبل يوم من مغادرة بيروت, حضر “تيرهيون” مع مرافقه سباق خيول نظمته الكلية الأمريكية حيث “كانت وجهتنا نهر الكلب وامتد السباق الى عدة أميال مروراً بضواحي بيروت حيث شاهدنا أكواخاً مبنية من الطوب اللبن والحجر, وأسوار من الصبار والقصب حتى وصلنا الى نهر بيروت. بعد ذلك استدرنا إلى اليسار, وسرنا بمحاذاة شاطئ البحر , عابرين خليج سان جورج”, حيث اضطر المشاركون الى الاقتراب كثيرا من الشاطئ بسبب تحويل في الممر لتسهيل مرور خط القطار, وكان عليهم مواجهة أمواج البحر التي كانت تتكسر عند اقدام الخيول, ثم بعد مسير لنصف ساعة وصلوا الى نهر الكلب.
اقتربت زيارة “تيرهيون” الى بيروت من نهايتها, فعاد من رحلة سباق الخيول مساءً, فتناول العشاء وقضى وقتا طويلاً وهو يحزم امتعته واغراضه “فعربة “الدليجانس” تغادر بيروت كل صباح في الساعة الرابعة, وكنا قد حجزنا مقاعدنا مسبقا.
في الثالثة صباحًا ، أيقظني “داوود” وقال إن الإفطار جاهز (…). انهينا الإفطار على عجل, وانطلقنا إلى المحطة فوجدنا ساحة المحطة مزدحمة بالفعل بالعاملين والركاب والتجار والمتسكعين.
“كان الليل مظلماً للغاية, والفوانيس القليلة عملت على زيادة اجواء الكآبة. وقف اثنان أو ثلاثة من الجنود أمام البوابة, و هم يوجهون الأوامر للمسافرين, فيما مجموعة من النساء تجمّعن في إحدى الزوايا ليتم نقلهن إلى حجرة الدرجة الثانية. لاحقا تلقى السائق, وهو رجل ضخم حليق الذقن يرتدي الزي الأوروبي, وحذاءً طويلاً, تعليمات الانطلاق من مدير المحطة”.
جلس “تيرهيون” ومرافقه في مقاعد الدرجة الأولى التي تتكون من ثلاثة مقاعد في الجزء الأمامي من العربة التي انطلق في رحلة استغرقت ساعتين للوصول الى أعالي جبل لبنان حيث توقفت لتغيير الخيول.
” كان الهواء قويا وشديد البرودة. وبعيدًا من البحر المتوسط, رأينا الشمس المشرقة ترسم أشرعة بيضاء على المياه الزرقاء. والضباب يغمر تلال بيروت بجدرانها البيضاء وسقوفها الحمراء وأشجارها الخضراء, فيما الطريق من خلفنا بدا وكأنه ثعبان اصفر عظيم يمتد من البحر الى الجبل.
________
*باحث في التاريخ/ جمعية تراث بيروت.